تنبّه الغربيّون إلى نظريّة الحقول الدّلاليّة أو المعجميّة الّتي تنتظم الكلمات في معانٍ متقاربة أو متكاملة، ولكنّ هذه النّظرية نسج خيوطها العرب في قديم تراثهم، وأشاروا إلى كثير من تفاصيلها، وإن لم يبلوروها البلورة الكافية. فلقد التفت العلماء العرب إلى الصّلة الدّلاليّة بين الكلمات، وأسّسوا بناء عليها معاجمَ المعاني أو الموضوعات، ككتاب الحيّات والعقارب لأبي عبيدة معمــر بن المثنّى (210ه)، وكتاب الذُّباب لابن الأعرابيّ (231ه)، والألفاظ الـــــــكتابيّة لـــــعبد الرّحمن بن عيسى الهمذانيّ (320ه)، ومبادئ اللّغة للإسكافيّ (420ه)، وفقه اللّغة للثّعالبيّ (429ه)، والمخصَّص لابن سِيدَه (458ه). وهذه المسألة يعرفها اللّغويّون حقّ الـمعرفة.
أمّا ما نحن بصدده اليوم فهو رصْد ما تنبّه إليه علماؤنا الأجلّاء من تجاور بعض الكلمات المنتمية إلى حقل معجميّ واحد، ولا سيّما في البلاغة. وهذا التّجاور يقع تحت عدّة أصناف.
فالصّنف الأوّل يعمد إلى الجمع بين الأشياء المتناظرة.
ومن ذلك مراعاة النّظير، وهي الجمع بين الشّيء وما يناسبه على غير تضادّ، ومنه الآية: {أُولِئَكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ}، وهكذا ناسب ذكرُ الاشتراءِ أن يُذكَر الرِّبح وتُذكَر التِّجارة.
ومن مراعاة النَّظير تشابهُ الأَطراف، وهو ختم الكلام بما يناسب أوّله في المعنى، نحو: {لا تُدْرِكُهُ الأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبيرُ}، فإنَّ اللُّطْفَ يناسِبُ أَلَّا يُدرَك الخالِقُ بِالبَصَرِ، والخِبْرَةَ تُناسب إدراكه كلِّ شيء.
ومن مراعاة النَّظير إيهام التَّناسب، وهو الجمع بين معنيين غير متناسبين، بلفظين يكون لهما معنيان متناسبان، وإن لم يكونا مقصودين، نحو: {الشَّمْسُ والْقَمَرُ بِحُسْبانٍ. والنَّجْمُ والشَّجَرُ يَسْجُدانِ}، فالنَّجْمُ هنا ليس ذلك الجِرْم الَّذي في السَّماء، بل هو النَّبات الَّذي لا ساق له، في حين أنَّ الشَّجر ما له ساق، لكنّ النّجم بالمعنى الأوّل يناسب ذكر الشّمس والقمر.
ويقترب من مراعاة النّظير التّرشيح في الاستعارة، وإن كان البلاغيّون قد ذكروه في موضع بعيد، وهو أن يُذكر مع الاستعارة شيء من لوازم المستعار منه، نحو: {الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ}، فقد استُعيرَ الـنّقضُ من الحبل، وذُكِر من لوازم الحبل أيضًا التّوثيقُ.
وإنّا لنجد التّرشيح في التّورية أيضًا، وهي أن يُذكَر فيها لازمُ المورّى به، أي المعنى القريب، نحو: {والسَّماءَ بَنينَاها بِأَيْدٍ}، لأنَّ اليد بمعناها القريب هي العضو المحسوس، وبمعناها البعيد القوّة والعظمة، وجاءت كلمة "بنيناها" تناسب عمل اليد الجارحة.
ونقيض التّرشيح في التّورية التّبيينُ، وهي ذِكْر لازم المورّى عنه، أي المعنى البعيد، ومثال التّورية المبيِّنة قولُ البحتريّ (284ه) في وصف فتاة:
ووراءِ تَسْدِيةِ الوِشاحِ مَلِيّةٌبالـحُسْنِ تَملُحُ في القلوبِ وتعذُبُ
والـتّسدية: مدُّ أقسام الثّوب الّتي تكون طولًا، فكلمة "تملح" لها معنى قريب، وهو الملوحة، ومعنى بعيد، وهو الملاحة، وقد قرنه الشّاعر بما يبيّنه، وهو "مليّة بالحسن".
وأمّا ردّ العجز على الصدر، فمثاله: {وحَرَّمَ عَلَيكُمْ صَيدَ الْـبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا}، و{خُلِقَ الإِنْسَانُ مِن عجَلٍ، سَأُريكُمْ آياتي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ}، حيث كرّر في آخر الآية اللّفظ المقارب للَّذي في صَدْرِها.
وقريبٌ منه التّذييل، وهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه، حتّى يظهر لمن لم يفهمه، ويتوكّد عند مَن فهمه، ومنه الآية: {ذلكَ جَزَيناهُم بما كَفَرُوا، وَهَلْ نُجازي إِلَّا الكَفُورَ}.
وقريب من ذلك الإرصاد، وهو أن يَبني المتكلِّمُ كلامه على خاتمة قد أرصدها له، فإذا اقترب القارئُ من موضعها توقَّعَ ماهيَّتها، ومنه الآية: {وما كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ ولكنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظلِمُونَ}.
والجدير بالذّكر أنّ النّحو يتضمّن الرّبط بين الكلمة وما يقاربها ضمن الجملة الواحدة، عبر مبحث التّوكيد، ومبحث البَدَل المطابق، ومَبحث الحال المؤكّدة، ومبحث المفعول المطلق. فمن الأوّل: {هَيهَاتَ هَيهاتَ لِما تُوعَدُونَ}. ومن الثّاني: {وقالَ مُوسى لأَخِيهِ هَارَونَ}. ومن الثَّالث: {فَتَبَسَّم ضَاحِكًا مِنْ قَولِها}. ومن الرَّابع: {وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيمًا}.
وقريب من ذلك في اللُّغة الجمع بين الشَّيء وما يناسبه من أفعال وصفات. وقد أبدع في ذلك الثَّعالبيّ (492ه)، فذكر في مجال الكمال أنّ الحَسَب يوصف بـ"لُباب"، والمجد يوصف بـ"صميم"، والعربيّ يوصف بـ"صريح"، والماء يوصف بـ"قَراح"، واللَّبن يوصف بـ"مَحْض"...
والصّنف الثّاني يعمد إلى الجمع بين العامّ والخاصّ.
ومن ذلك عطف الخاصّ على العامّ، كقوله تعالى: {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ}. فلفظ (الرّوح)، وهو "جبريل" خاصّ، ولفظ (الملائكة) عامّ.
ومن ذلك عطف العامّ على الخاصّ، كقوله تعالى: {يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا}.
وثمّة في النّحو ما يشبه ذلك، على غير جهة العطف، وهو بدل الجزء من الكلّ، وبدل الاشتمال. فمثال الأوّل: {وارْزُقْ أهلَهُ مِن الثَّمَرَاتِ مَن آمَنَ باللهِ واليومِ الآخِرِ}، فـ"مَن" بدل جزء من كلّ، والمبدل منه "أهله". ومثال الثّاني {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الـحَرامِ قِتالٍ فيه}، فـ"قتال" بدل اشتمال من "الشّهر".
والصّنف الثّالث يعمد إلى الجمع بين الأشياء المتضادّة.
ومن ذلك المطابقة، وهي تعني الجمع بين الشّيء وضدّه، وتكون مطابقة إيجاب، نحو: {فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئاتِـهم حَسَنَاتٍ}، وتكون مطابقة سلب، نحو: {قُلْ هَلْ يَستوي الَّذينَ يَعلَمُونَ والَّذينَ لا يَعْلَمُونَ}.
وقد تكون المطابقة ظاهرة، كالَّذي تَقدَّم، أو خفيّة، نحو: {مِـمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغرِقُوا فأُدْخِلُوا نارًا}، إذ الإغراق يخفي معنى الماء، والماء نقيض للنّار.
وقد يرد في الكلام إيهام التَّضادّ، وذلك يكون في صورتين. أمّا الأولى فأن يكون أحد اللَّفظين في الحقيقة، والآخر في المجاز، ومنه قول دِعبل بن عليّ الخزاعيّ (245ه):
لا تَعْجَبي يا سَلْمَ مِن رَجُلٍضَحِكَ الْمَشيبُ بِرَأْسِهِ فَبَكَى
وأمّا الثّانية فأن يُوهِم اللّفظ أنّه ضدّ، وهو مقارب للضّدّ، كقول الشّاعر:
يُبدي وِشاحًا أَبْيَضًا مِن سَيْبِهِوالجوُّ قَدْ لَبِسَ الوِشاحَ الأَغْبَرَا
فالأغبرُ ليسَ ضِدًّا للأبيض، وإنّما ضدّه الأسود.
ويدخل ضمن المطابقةِ المقابلةُ، وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر، ثمَّ يُؤتى بالأضداد على التّرتيب، نحو: {فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا}، و{يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}.
وثمّة تأكيد المدح بما يشبه الذّمّ، وهو إطلاق نفي العيب، ثمّ استثناء حالة توحي بأنّها عيب، ولكنّها صفة مدح تُدرَك بعد التَّأمّل. ومن ذلك قول النّابغة الذّبيانيّ (18ق.ه.):
ولا عَيبَ فيهم، غَيرَ أنَّ سُيوفَهُمبِهِنَّ فُلُولٌ مِن قِراعِ الْكَتائِبِ
وليست كثرة الفلول (الثُّلَم والانكسارات) في السّيوف عيبًا كما يتوهّم السّامع، بل هي دليل على شدّة البأس، وكثرة خوض المعارك. وهنا نجد أن كلمة "العيب" استدعت ذكر كلمة من حقلها المعجميّ، وهي "فلول".
ومنها العكس، وهو أن تجعل في الجزء الأخير من الكلام ما جعلته في الجزء الأوّل، وبعضهم يسمّيه التَّبديل، ومِثالهُ: {يُخرِجُ الْـحَيَّ مِنَ الْـمَيِّتِ ويُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْـحَيِّ}.
ومنها الرّجوع أو الاستدراك، وهو أن يَذْكَرَ المتكلِّم شيئًا ثمّ يرجع عنه، أو ينقضه، ومثاله: {إذْ يُريكَهُم اللهُ في مَنامِكَ قليلًا، ولو أراكَهُم كثيرًا لَفَشِلْتُم...}..
وقد يكون الأمر بِضمّ الكلمات المنسجمة، والكلمات المتنافرة، وهذا ما سمّاه البلاغيّون بـجمع المؤتلف والمختلف، وذكروا منه الآية: {إنَّ اللهَ يَأمُرُ بالعدلِ والإحسَانِ وإيتاءِ ذي القُرْبى، ويَنهى عَنِ الفَحشاءِ والـمُنكَرِ والْبَغْيِ}، فالمؤتلف: العدل والإحسَان وإيتاء ذي القُرْبى، والمؤتلف أيضًا: الفَحشاء والـمُنكَر والْبَغْي، والمجموعتان مختلفتان في ما بينهما.
إنّما جمعتُ هذه اللّفتات المتناثرة، كي تنتشر بين الباحثين، وتكون نواة لدراسةٍ جدّية في إطلاق نظريّة عربيّة متكاملة في الحقول المعجميّة، تستند إلى التّراث العريق، وتفي بحاجات المتكلّم العربيّ.




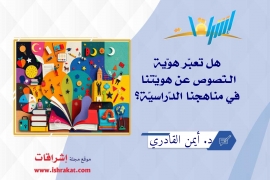

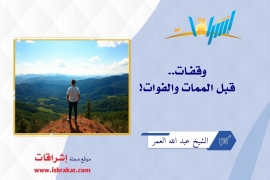

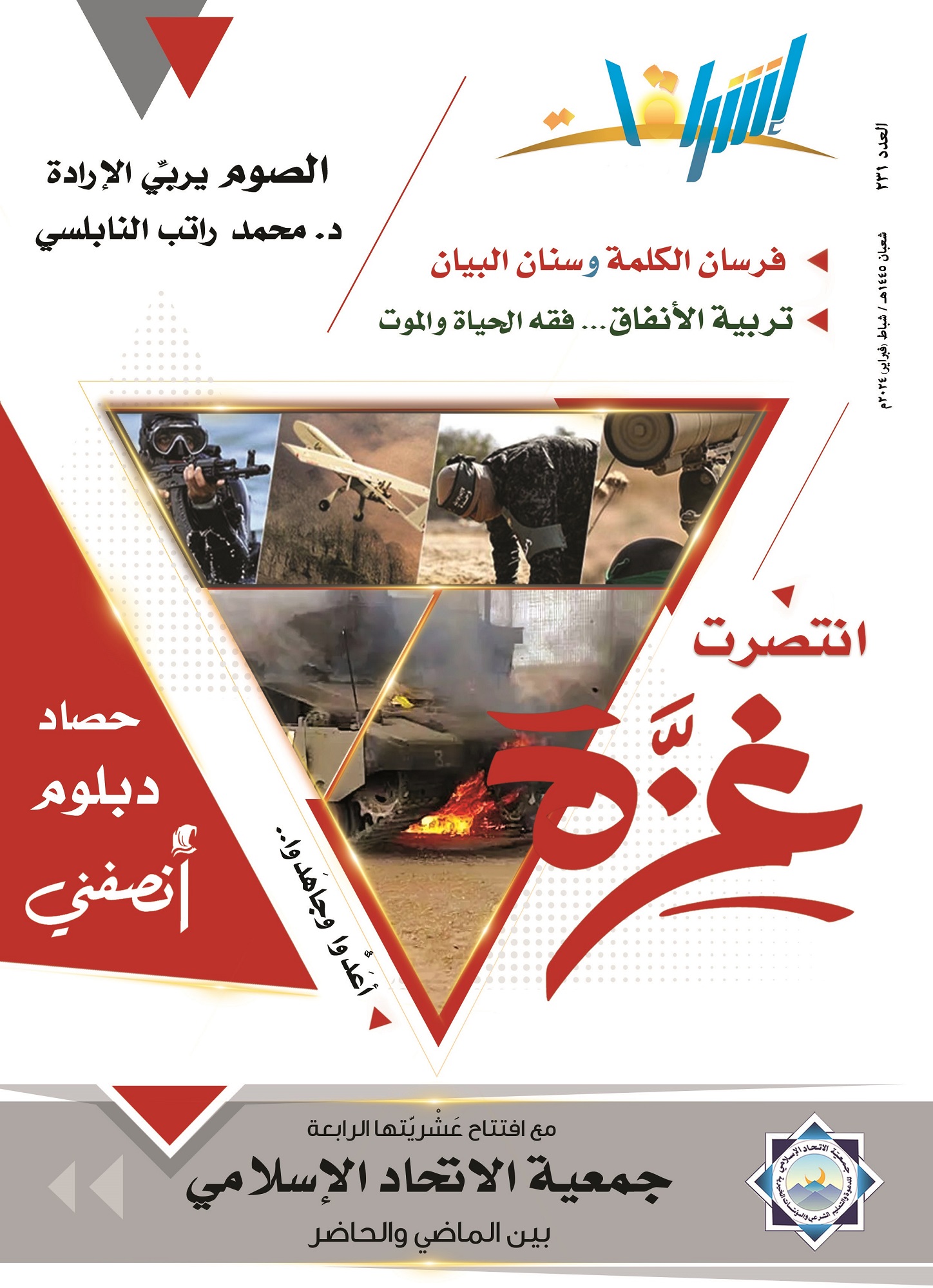


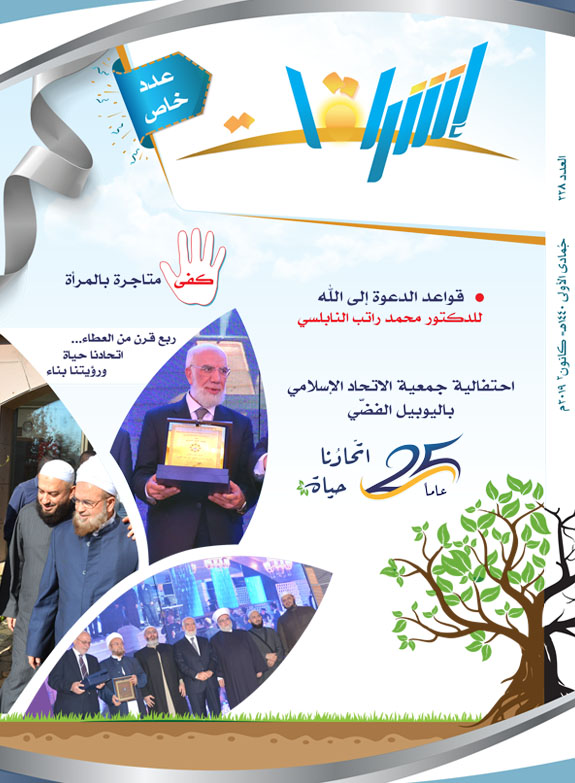










أهمية الوعي حول تأثيرات الأفلام الكرتونية
كتاب 'صراع الدول الأوروبية على فلسطين في القرن التاسع عشر'
لماذا أتحجَّب؟
هل تفاجأتم بفضائح إبستين؟
عَظٌمتْ آثارُهم على الرغم من قِصَر أعمارهم