مَن تنكَّر لماضيه تنكّر له يومُه!
في غَمرةِ البحرِ الجارِف، بحرِ العَولَمة، تنشأ مفاهيم غريبة في مضمار الثّقافة، فبعدَ أرتالِ الكتبِ الّتي نفخَت في بوق "الحداثة"، وقلّصت دائرة الـتّراث، وجرَّحَتْه، أطلّ علينا الـنّصف الثّاني من القرن العشرين بـالمصطلح المتصدّر "ما بعد الحداثة" (Post modernism)، وهو كما عرّفه قاموس أوكسفورد الإنكليزيّ: "نمطٌ ومفهومٌ في الفنون يتميّز بالرّيبة من النّظريّات والأيديولوجيّات، وبتوجيه الانتباه إلى مواضع الاتّفاق". وفي الواقع، تتجاذَب هذا المصطلح تعريفات متضاربة، وتطبيقات متباينة، لكنّ الأساس محاولة الـتّنصّل من القديم، وعدم اتّخاذه ركيزة لأيّ نهضة، والتّنكّر للمعتقدات الرّاسخة، والـتّشكيك بمفاهيم الهويّة.
وفي سياق هذا كلّه تلقّف الفكرُ الأميركيّ العولمة ومفرداتها الثّقافيّة، لأنّها تهمّشُ حضارات الشّعوب وأدبيّاتِـها المتمايزة، وتنأى عن تعميق دراسة خصائص الـتّراث الإنسانيّ القديم، وما ذلك إلّا لأنّ الأميركيّين لا تاريخ لهم قياسًا إلى باقي الأمم، فدولتُهم حديثة، قامت على أنقاض حضارة الهنود الحمر، فتاريخ الأميركيّين تاريخ دامٍ ينبغي حجبه، ولذلك حيَّدوا مسألة التّاريخ والتّباري بصحائفه، ورحَّبوا بالحداثة وما بعد الحداثة والعولمة...
ولقد شهدنا نتيجة ذلك محاولات كثيرة لفكّ الارتباط بين الدّراسة الأدبيّة للـنّصّ والعامل التّاريخيّ، والمراد به فهم العصر الأدبيّ، وتدفّقتِ الكتابات الـنقديّة الّتي تعيبُ التّحقيب التّاريخيّ (periodization) للأدب.
يجدرُ بنا في مستهلّ الرّدّ أن نعلم أنّ دراسة الـنّصّ القرآنيّ بدأت مرتبطة بالسّياق التّاريخيّ، ضمن ما يُعرَف بـ"أسباب الـنّزول"، ومن أشهر الكتب الّتي أفردت لهذا العلم كلّ اهتمامها "أسباب النّزول" للواحديّ (468ه)، و"العجاب في بيان الأسباب" لابن حجر العسقلانيّ (852ه)، و"لباب النّقول في أسباب النّزول" للسّيوطيّ (911ه).
وقد ارتبط هذا العلم بنسخِ الأحكام أيضًا، وهو ما حفلت به مصنّفات كثيرة، منها "كتاب النّاسخ والمنسوخ" لقَتادة بن دِعامة السُّدوسيّ (117ه)، و"النّاسخ والمنسوخ" لابن حزم (456ه)، و"المصفّى بأكفّ أهل الرّسوخ من علم النّاسخ والمنسوخ" لابن الجوزيّ (597ه).
وكذلك دخل في دراسة السّياق التّاريخيّ للـنّصّ معرفة المكّيّ والمدنيّ، ومن الكتب الّتي اهتمت به "كتاب المكّيّ والمدنيّ" لمكّيّ بن أبي طالب القيسيّ (437هـ)، و"المكّيّ والمدنيّ في القرآن، واختلاف المكّيّ والمدنيّ في آيه" لأبي عبد الله محمّد بن شريح الرّعينيّ المقرئ (476هـ).
ولا يعني طبعًا ربطُ الـنّصّ القرآنيّ بسياقه التّاريخيّ أن يفقد محتواه بانقضاء زمانه، وفي ذلك قال علماء أصول الفِقْه: "العِبرة بعموم اللَّفْظِ لا بخصوص السَّبب".
وفي إطار الدّراسات الأدبيّة الأولى الرّائدة، برز ابن سلّام الجمحيّ (231ه)، الّذي صنّف الشّعراء في كتابه "طبقات فحول الشّعراء" وفق حقبٍ زمنيّة، فكانوا جاهليّين ومخضرمين وإسلاميّين. وقد فعل ذلك أسوةً بما فعله علماء الحديث حين صنّفوا رجال السّند إلى الصّحابة والتّابعين وتابعي التّابعين.
والحقّ أنّها منهجيّة جيّدة، وإلّا فكيف ندرس الفرزدق (110ه)، ونحن لا نعرف الظّروف التّاريخيّة للشّعر السّياسيّ في عصره، وانتماءَه إلى طرف معارض في بدايات عمره الأدبيّ؟ وكيف ندرس أبا نواس (196ه)، ونحن لا نعرف طبيعة عصره القائمة على كثرة العلوم الكونيّة، والفلسفة والاعتزال، والشّعوبيّة؟ وكيف ندرس الجاحظ (255ه) ونحن لا نعرف الأوضاع الاقتصاديّة الّتي أدّت إلى فقر قطاعات واسعة في المجتمع، حتّى انتشر البخل؟ وكيف ندرسه، ونحن لا نعرف حركة الجدال الحادّ في عصره، وانتماءه إلى الاعتزال؟ هذه الأمور لا تقاربها نظرة عاجلة من خلال حياة الأديب.
وثمّة قضايا مرتبطة بعصر واحد، لكنّها امتدت إلى سائر العصور التّالية، فلا بد من فهمها منذ البداية، مثل الوقوف على الأطلال، وذكر النّاقة، والدّعاء بنزول المطر على القبر، ومخاطبة الاثنين، وهذه كلّها مرتبطة بالسّياق الاجتماعيّ المعيشيّ، وترتبط بأجواء الحضارة عامة، وينبغي أن نعرف جذورها.
وقد أقرّ كثير من الدّارسين الغربيّين بدور التّاريخ وعصوره في تبيان خصائص النّصّ الأدبيّ، فكان أن برزت نظريّة الفيلسوف والمؤرّخ الفرنسيّ هيبوليت تين (1828م)، المعروفة بالمنهج التّاريخيّ، وهي ترى أنّ الأدب هو نتاج لثلاثة عوامل رئيسيّة: العرق أو الجنس (الاستعدادات الفطريّة المتوارثة)، والبيئة (الوسط الجغرافيّ والاجتماعيّ)، والزّمان (اللّحظة التّاريخيّة بأحداثها السّياسيّة والاجتماعيّة وثقافتها)، وتُفَسِّر هذه العوامل مجتمعةً الظّاهرة الأدبيّة، إذ يرى تين أنّ الأدب يخضع لقوانين حتميّة أشبه بقوانين الطّبيعة.
واهتمّ الأدب المقارن وفق التّصوّر الفرنسيّ بالبعد التّاريخيّ في الأعمال الأدبيّة، وبدأ ذلك مع جان جاك أمبير (1864م) وأبل فرانسوا فيلمان (1870م)، فالـنّصّ الّذي نريد إثبات أنّه متأثّر بنصّ آخر لا بدّ أن تقوم شواهد تاريخيّة على أنّه لاحق له، وأنّ صاحبه اطّلَع على الـنّصّ القديم.
وكان دو سوسير (1913م) قد فتح للتّاريخ الباب في الدّراسة الألسنيّة الحديثة عــــبر طرح منهجه التّـــــعاقبي (Diachronic Approach)، لاستخلاص السّمات والمتغيِّرات وَفق تبدّل الزّمان. ووطّد كذلك أسس السيميائية، وهي دراسة العلامات والرموز ودورها في تشكيل المعنى، وتمثيل الواقع، وتفسير التّجارب الإنسانيّة، فالرّموز، من ألوان وأشكال وأرقام وأحرف وأسماء وكواكب، تكتسب دلالات مختلفة، بالعودة إلى استخداماتها في حقب زمنيّة معيّنة.
وقد يتذمّر بعض الـنّقّاد من هذه العصور الأدبيّة، لأنّ واجهتها سياسيّة، فهي تريد للأدب قسْرًا أن يكون جاهليًّا، أو إسلاميًّا، أو أمويًّا، أو عبّاسيًّا، ولو ثار على النّظام القبليّ الجاهليّ، أو على حكومات الخلفاء الرّاشدين، أو على الأمويّين، أو على العبّاسيّين. والصّحيح أنّ العصور السّياسيّة تصطبغ دومًا بمتغيّرات ثقافيّة وفكريّة وأدبيّة لا يمارى فيها، وليس قبولنا بوجودِها إذعانًا لهذه الواجهة السّياسيّة أو تِلك.
وخير مثال في تاريخنا حركة "الصّعاليك"، فنحن لا نستطيع إدراك خصائص شعرهم إلّا بالعودة إلى الوضع القبليّ والاجتماعيّ في الجاهليّة، كي نلاحظ مدى تمرّدهم على قوالب الشِّعْر نفسِها، إذ لم يكتفوا بالـتّمرّد على الـنّظام السّياسيّ المتمثّل في القبيلة. وكذلك حركة "الخوارج"، إذ لا نستطيع فهم خطبهم وشعرهم إلّا بالـتّبسّط في طبيعة الصّراعات العسكريّة والعقَديّة في آخر عصر الخلفاء الرّاشدين، وبداية العصر الأمويّ.
وثمّة مثال آخر قريب في حركة "الشّكلانيّين الرّوس" (opoyaz)، وكانت حركة نقديّة وأدبيّة نشأت في أوائل القرن العشرين، ثمَّ ضاقَت بها الثّورة الشّيوعيّة النّاشئةُ آنذاك، لأنّها لم تستجب لأسلوبها في مقاربة الأدب بخلفيّة ماركسيّة، فتفكّكت "الشّكلانيّة الرّوسيّة".
وفي الواقع يثور النّاس كثيرًا في وجه السّلطة السّياسيّة لأسباب ثقافيّة أو اجتماعيّة، لأنّهم يدركون مدى الارتباط بين الطّرفين. وبناء عليه، لا نملك في دراسة الأدب الثّوريّ نفسِه إلّا أن نفهم العصر السّياسيّ الأدبيّ. وليس معنى أنَّ عصر النَّهضة في الأدب بدأ بحملة نابليون بونابرت (1812م) أنّنا نوافق على الحملة، لكنّ الأوضاع الفكريّة والثّقافيّة والأدبيّة حتمًا تغيّرت، كما سبق أن تغيّرت مع حملة هولاكو خان (664ه/1265م) الّتي دمّر بها الدّولة العبّاسيّة عام 656ه/1258م، وإن كنّا لا نؤيّد هولاكو!
وفي الختام، نؤكِّد أنّه لا بدّ من ترسيخ الصّلة بين الأدب والتّاريخ، حتّى يبقى الـتّراث بنكهةٍ مميَّزة، نكهة الأصالة والانتماء، ولا سيّما أنّ مناهج التّاريخ في مدارسنا لا تولي ماضي أمّتنا أو حاضرها قسطًا وافيًا من الاهتمام، وتبقى الأضواء مسلّطة على حضارات وثنيّة مندثرة، أو مَدنيّاتٍ غربيّة مادّيّة.



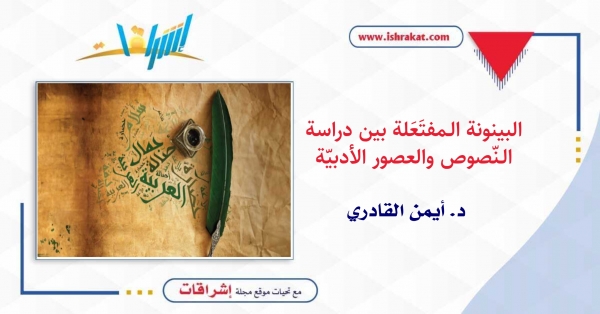
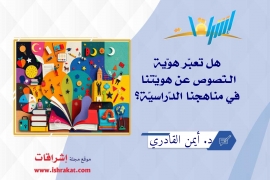

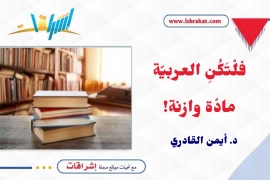

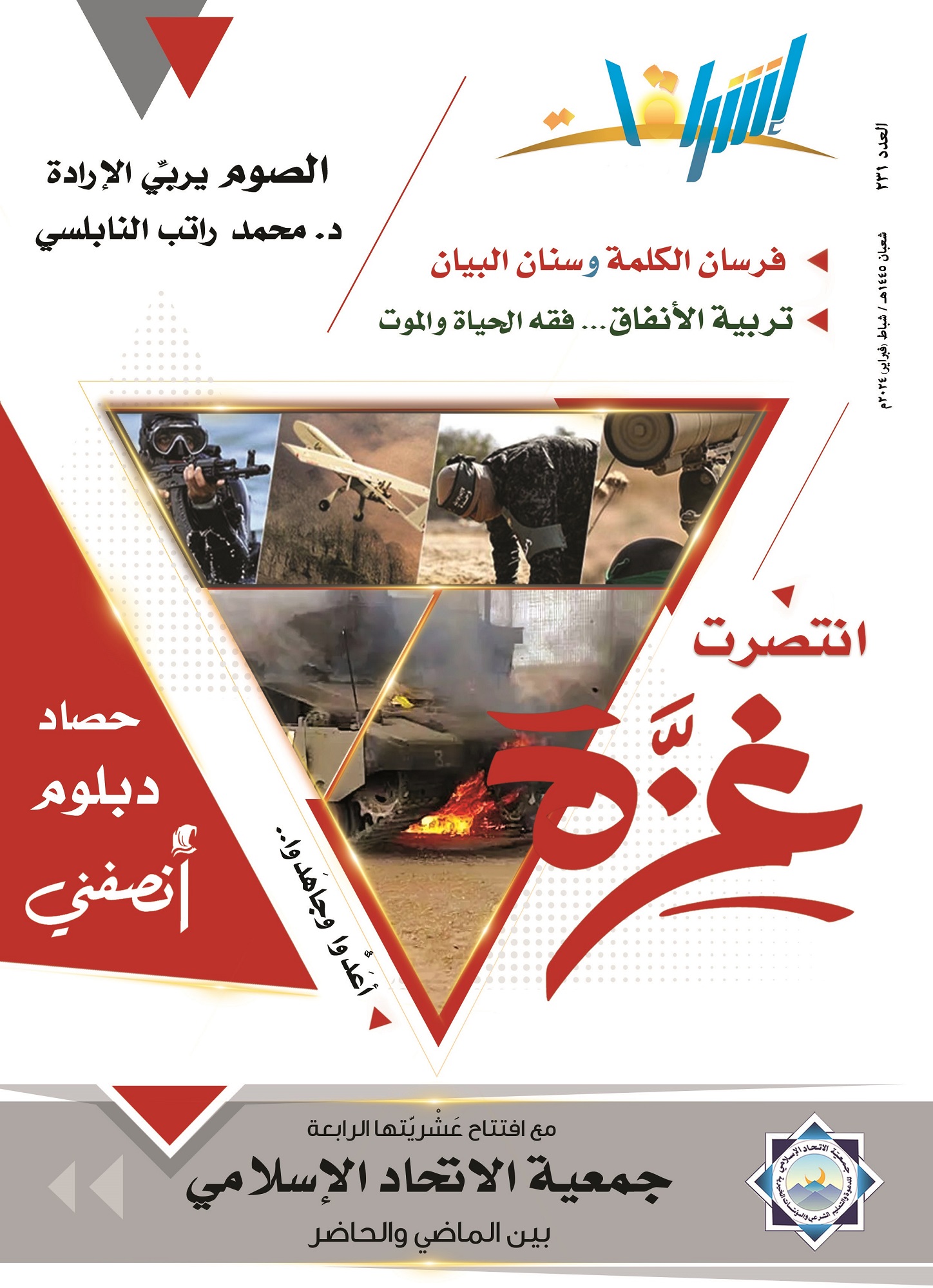


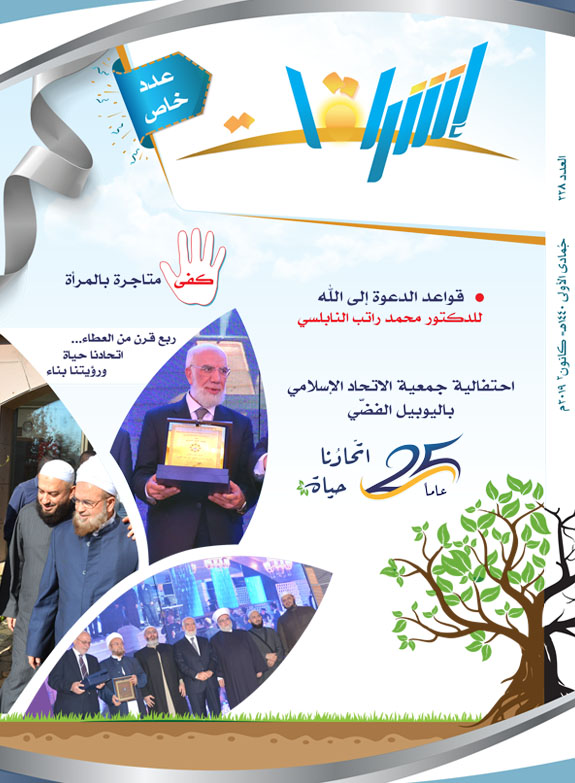










هل تفاجأتم بفضائح إبستين؟
عَظٌمتْ آثارُهم على الرغم من قِصَر أعمارهم
حجابكِ وقفة عزّ
الحجاب وقاية واستقرار
شعرتُ بما شعرَ به عُمر!