الدراسة اللُّغوية بارعة في كشف النقاب عن جمال القصة والرواية
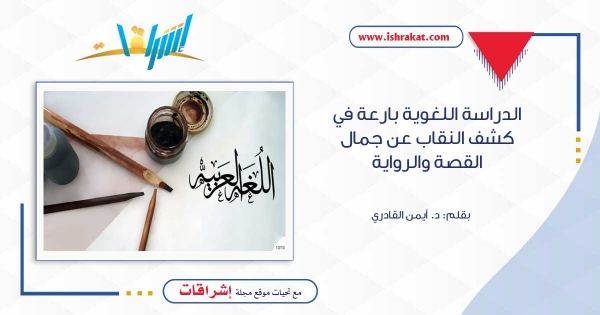
تمتلك أصول اللغة العربية قدرات عظيمة على إبراز جماليات النص الأدبي، فالمستويات اللغوية (المستوى الصوتي والمستوى المعجمي والمستوى الصرفي والمستوى النحوي) قادرة على اقتحام النص، والتغلغل في أبعاده الجمالية الفنية، وسبر أدبيته، وتبيان مكامن الإبداع فيه. وهذا الأمر في واقع الحال قائم في وجدان النقَّاد العرب في أقدم نصوصهم، وهو كذلك غاية ما وصل إليه الفهم اللغوي الحديث ابتداءً من فرديناند دوسوسير، رائد المدرسة البنيوية.
- لقطات من المستويات اللغوية في النقد القديم
أما نقادنا القدامى فـنجد أنهم كانوا شعراء الجاهلية الذين انتقدوا زملاءهم، في أمور لغوية.
فحين سمع طرفة بن العبد (569م) قول المسيَّب بن علس (575م):
وقد أتناسى الهمّ عندَ ادّكارِهبناجٍ عليهِ الصّيعريّة مِكدَمِ
قال: "استنوق الجمل"، رافضًا أن يخرقَ زميلُه السورَ المعجمي لكلمة "الصيعرية، إذ هي عيب في جلد الناقة، فكيف يُطلَقُ على الجمل؟
وحين تنبَّه أهل المدينة إلى إقواء النابغة الذبياني (605م) في مطلع قصيدة له:.
أمنَ آل مــــــــــيّة رائح أو مغتدِعجــــــلان ذا زاد وغير مزوَّدِ
زعم البوارح أنَّ رحلتنا غـــدًاوبذاك خبَّرنا الغراب الأسودُ
نجد أنهم التفتوا إلى أمر لغوي: التباين الصوتي في الإيقاع بين نهايتي البيتيْن، فالدال مكسورة في الأول، ومضمومة في الثاني.
وحين قرأ حسان بن ثابت (54ه/673م) أمام النابغة الذبياني في سوق عكاظ:
لنا الجفناتُ الغُرُّ يَلمعْنَ بالضُّحىوأسيافُنا يَقْطُرْنَ مِنْ نجدةٍ دمــــا
عاب عليه النابغة مسألة صرفية، وهي أنَّه استعمل الجمع "أسياف" المفيد للعدد القليل، بدلًا من "سيوف" المفيد للعدد الكثير، وكان اللفظ الثاني أنسب في مقام الفخر بالقبيلة. وعاب عليه أنه قال "يقطرن" واقترح أن يقول "يَجْريْن"، لأنها بدلالتها اللغوية أقوى في إثبات كثرة الدماء على السيوف.
وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع بيت سحيم عبد بني الحسحاس (40ه/660م):
عميرةَ ودّعْ إن تجهّزت غازياكفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا
فاقترح عليه أن يقول: "كفى الإسلام والشيب للمرء ناهيا"، معتمدًا على التقديم والتأخير، وتلك مسألة نحوية تركيبية، وتندرج أيضًا في البلاغة، ضمن علم المعاني.
وجاء في العقد الفريد أن عمر بن الخطاب (23ه/644م) قال لابن عباس (68ه/687م): "أنشدني لأشعر الناس، الذي لا يعاظل بين القوافي ولا يَــــــــتــــــــَــــتّــــــبَّعُ حُوشيّ الكلام". قال: "ومن ذلك يا أمير المؤمنين؟" قال: "زهير بن أبي سلمى (609م)".
ولا ريب أن هذا النقد المرتكز على اللغة تنامى التنامي المحمود حتى أوصلنا إلى علم المعاني مع عبد القاهر الجرجاني، ولئن شمل محاور أخرى غير اللغة، لكنها كانت العمود الفقري في الدخول إلى جمال النص.
- النقد الغربي الحديث يتبنى المستويات اللغوية:
أرسى فرديناند دو سوسير (1913م) أسس الألسنية في محاضراته التي نشرت عام 1916، وأرسى في الأذهان فكرة البنيوية القائمة على اعتبار اللغة بنية، يتمّ إظهارها من خلال لحظ وحداتها الأساسية.
وتزامن ذلك مع ظهور الــــــــدراسات الأسلوبية (Stylistics) بــــــوصفها مـــــحاولات منهجية لدراسة النصوص، بــــرؤية جديدة تستــــــند إلى عـــــلوم اللسانيات، بإجراءات توافق التحليل البلاغي في أوجه، وتتجاوزه في أوجه. ومن ذلك الأسلوبية الصوتية، والأسلوبية البلاغية. فالأسلوبية تفترض أن لكل نص بلاغته الخاصة وأحكامه الجمالية النابعة من داخله، وتحقق انسجامًا بين الرؤية النقديَّة للوظيفة الجمالية هذه، ومطابقتها لمقتضى الحال، استنادًا إلى رؤية شمولية لعلوم اللسانيات ترفض التجزئة، وتبحث في العلاقات داخل نسيج النص، وتتابع الشحنات المنبعثة منه.
وقد وضع ميشيل ريفاتير (2006م)، وهو باحث ألسني، وناقد أدبي بنيوي أمريكي، وأستاذ في جامعة كولمبيا، كتابه "الأسلوبية البنيوية" عام 1971، ثم أتبعه بكتاب "صناعة النص" 1979، وفيه يرى أنه ليس من نص أدبي دون أدبية، ولا أدبية دون نص أدبي. ويرى ريفاتير أن الكشف عن أدبية النص الأدبي، بتحليل النص من خلال لغته.
- هل النصوص السردية قلعة لا تدخلها آليات الدراسة الأسلوبية/اللغوية؟
أشاع بعض الدارسين أنّ القصص والروايات لا تُدرَس إلا من زاوية المنهج السردي، ولا تصلح مقاربتها في دراسة أسلوبية ترتكز على معطيات البلاغة العربية، أو الألسنية المعاصرة!
وفي الرد على هذه المقولة لا بد من ملاحظة عدة أمور:
الأمر الأول أنَّ القصة أو الرواية نصّ، والأسلوبية لم تنأ بنفسها عن أي نص، والعموم يدخل تحته الخصوص. وإذا لم يرد لدى الأسلوبيين استثناء لنوع من النصوص، فلا يملك غيرهم وضع الحواجز، ولا سيما أنَّ السرد لا ينقل النص عن أن يبقى مؤسسة لغوية فيها إيقاع صوتي، ونبر وتنغيم، وفيها كلمات تخضع للدراسة المعجمية وآليات الاستبدال، وفيها أبنية صرفية يختار منها الكاتب ما يوافق الدلالة، وفيها تراكيب نحوية يطرأ عليها من الحذف والتقديم والتأخير والزيادة والتعديل ما ينفذ إلى عمق المعنى.
والأمر الثاني أنَّ المكتبة العربية زاخرة بالدراسات البحثية التي قاربت أعمالًا سردية مقاربة أسلوبية.
- ففي دراسات السرد القرآني نجد مثلًا:
- الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية- محمود السيد حسن مصطفى- مؤسسة شباب الجامعة- 1981م.
- البناء اللغوي في سورة الكهف- محمد الأمين بابكر علي- رسالة مقدمة لنيل درجة (دكتوراه الفلسفة)، في اللغة العربية تخصص (علم اللغة)- جامعة الجزيرة، يونيو 2014م.
- السمات الأسلوبية في القصة القرآنية، قصة إبراهيم عليه السلام أنموذجًا- يوسف سليمان الطحان- مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية- جامعة الموصل- المجلد 10- العدد 3- 2011م.
- الصراع في القصص القرآني: دراسة لغوية فنية- بيان محمد وسيم الشيخ رشيد البكري (رسالة جامعية)- كلية الآداب- الجامعة الأردنية- 2013.
- ظاهرة التكرار في القصة القرآنية دراسة تحليلية دلالية لغوية- سنتا محمد علي والصادق أبو حسن أبو قطر- المجلة العلمية لجامعة الإمام المهدي- العدد 10- ديسمبر 2017م.
- من صور الإعجاز اللغوي في القصص القرآني (دراسة بنيوية في سورة الكهف)- خليدة بن عياد- دار مجدلاوي- 2013م.
- قصة ابني آدم، دراسة لغوية- محمد حسين علي- دار مجلة الأستاذ- جامعة كربلاء- كلية التربية- المجلد الأول- العدد 216- 2016- ص163-198.
- وفي دراسات أدب الأطفال نجد مثلًا:
- أدب الأطفال، دراسة لغوية تطبيقية على قصص الأديب عبد التواب يوسف- د.نبوية الجر- جامعة عين شمس.
- المعايير اللغوية لقصة الطفل العربــي- محمـد علي المصري (أطروحة دكتوراه)- جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا- كلية الدراسات العليا- قسم اللغة العربية- 2007م.
- وفي دراسات الرواية نجد مثلًا:
- أسلوبية الرواية/ مدخل نظري- حميد لحمداني- دار النجاح الجديد- الدار البيضاء- ط1- 1989م.
- البنية اللغوية في الرواية الجزائرية المعاصرة/ رواية لاروكاد لعيسى شريط أنموذجًا- منى مسعي محمد- رسالة ماستر- جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي- الجزائر- 2016.
- رواية ضفاف أخرى، دراسة أسلوبية لغوية- مؤيد مهدي فيصل- مجلة جامعة ذي قار- 2016- المجلد 11- العدد 3- ص1-21.
- النسيج اللغوي في روايات الطاهر وطار- عبد الله عمر محمد الخطيب- أطروحة دكتوراه- الجامعة الأردنية- آب 2006.
- اللغة والرواية- بلال كمال رشيد- دار فضاءات للنشر والتوزيع- عمان- 2011.
- وفي دراسات القصة والقصة القصيرة نجد:
- جماليات اللغة في القصة القصيرة جدًا في عُمان/ الخطاب المزروعي أنموذجًا- د.نهلة الشقران- جريدة الوطن العمانية- 2015م.
- رواية "كلمة الله" لأيمن العتوم، دراسة أسلوبية نصية- د.حنان سعادات عبد المجيد عودة- الجامعة الهاشمية.
- العناصر اللغوية ودورها في تحقيق التماسك النصي في قصة تحت المظلّة لنجيب محفوظ- محمد عبد الرحمن حسن الحجوج- مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية- جامعة الجزائر- المجلد 11- العدد 21- ص27-52.
- العناصر النحوية في قصة قصيرة "نيللي" لعبد الحميد بشارة عند ليج وسورت: دراسة أسلوبية- جيهان نور بهيرة- كلية العلوم الإنسانية في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية- مالانج- 2019م.
- المقاييس والأحكام اللغوية والفنية في القصة القصيرة العربية- جعفر كمال- الحوار المتمدن- العدد: 2340 – 12/ 7/ 2008م.
- وسائل التماسك النصي ودورها في بناء القصة الدينية الموجهة إلى الطفل، دراسة تحليلية لقصة يوسف عليه السلام- يسمينة عبد السلام- مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية- جامعة الجزائر- المجلد 10- العدد 20- ص395- 419.
- الاتساق النَّصي في نموذجين من المجموعة القصصية "دمشق الحرائق" لزكريا تامر- الطالبة نور الفاتحة بنت حنفي- الجامعة الأردنية، 2018: أطروحة دكتوراه درست الاتساق النصي في قصة "البستان"، وقصة "الليل".
- صورة بخيل الجاحظ الفنية من خلال خصائص الأسلوب في كتاب البخلاء- أحمد بن محمد بن امبيريك- دار الشؤون الثقافية العامة- بغداد- 1986م.
والأمر الثالث أنَّ الدراسة السردية ذاتها يمكن رفدها بمكونات لغوية- أسلوبية تدخل إلى أعماق السرد، وتقف عند أهمّ منعطفاته.
- فالباحث اللغوي في القصة قد يلاحظ استخدام الكاتب أنواعَ المعرفة (ولا سيما المحلّى بـ"أل"، واسم العلم)، في إبراز هويات الشخصيات وجعلها قريبة من القارئ، أو يلاحظ استخدام النكرة في إضفاء بعض الغموض على الشخصيات أو تهميشها. ولعله يرى في ثنائية المعرفة والنكرة أيضًا، أشياء مماثلة في تأطير الزمان أو المكان، فإذا قال الكاتب إن الأحداث جرت في "بيروت" في شهر "أيلول"، كان الأمر مختلفًا عن قوله إنها جرت في "مدينة" في "شهر" من السنة.
- وكذلك تمكّن الباحثَ قواعدُ اللغة ومهاراتها من رصد المواضع التي اعتمد الكاتب فيها صيغة المجهول، ليرى مراده: أيقصد تجهيل الرواة والشخصيات؟ أم يقصد شيئًا آخر مما أشار إليه علماء اللغة في هذا المجال؟
- وله أن يلاحظ استخدام الضمائر، ففي السيرة الذاتية مثلًا لا بد أن يكثر ضمير المتكلّم المفرد، إلا إذا شاء الكاتب سرد حياته بأسلوب ملتوٍ، وجعل نفسه في صيغة الغائب، كما فعل طه حسين في "الأيام" حين أشار إلى ذاته بـ"الفتى"، وصارت ضمائر الغائب تحتوى تفاصيل الأحداث.
- والأصل في السرد استعمال الفعل الماضي، لأنّ الأحداث جرت وانقضت قبل أن يبدأ الكاتب بصياغتها ونَقْلِها إلى قرَّائه. لكنه قد يستحضر الفعل المضارع، ليلبس الأحداث ثوب الحاضر، فيبعث الحيوية في الرواية أو القصة، ونعيشها كما لو أنها تُبثُّ مباشرةً.
- وفي تتابع الأحداث لا بد من اعتماد أدوات ربط مناسبة، مثل حروف العطف: الواو، والفـاء، وثمّ. ويضاف إلى ذلك حروف الجرّ (من- إلى- في- منذ) فهي تناسب إطار الزمان، وبما أن إطار المكان مؤازر لإطار الزمان في القصة، نحتاج إلى (على). ولكلا الإطارين نحتاج إلى ظروف زمان ومكان (فوق- تحت- قبل- بين- خلال- متى- أين- أيّان..). ووظيفة الناقد الأسلوبي أن يرصد هذه العناصر اللغوية في النص السردي، ويرى كيف وزّعها الكاتب، وتصرّف بها؟ ومن ذلك أن يصنِّف هذه الظروف بين أن تكون محدّدةً (غدًا- الآن- هنا..)، أو مبهمة (خلف- بعد- عند...)، ويربط هذا التصنيف بثنائية الوضوح والغموض في تظهير الأحداث والشخصيات والحوار....
- والمعروف أن الجمل الفعلية تدلّ على التغيّر والتقلّب، وهذا جوهر الأحداث التي يقوم سردها على لحظ التبدّل، فتكون الجمل الفعلية مطلوبة بإلحاح في القصة أو الرواية. وحين يشاء الكاتب إضفاء بعض صور الوصف في ثنايا القصة لا بد أن يستلّ من جعبته مجموعة من الجمل الاسمية المناسبة لدلالة الثبات والاستقرار في الموصوفات.
- والسرد كما لا يخفى إخبار، فينبغي أن تحضر الجمل الخبرية بكثافة، لكن الكاتب قد يدرج الحوار بين الحين والآخر، لإضفاء الحيوية على نصه، وهنا دور الجمل الإنشائية الطلبية.
- وكذلك قد تقصر الجمل لتنسجم مع الأحداث السريعة، وتطول لتواكب الأحداث البطيئة.
- ويبقى أن ندرك أن الكاتب لا يستطيع إبراز شخصياته بالقدر الوافي، والتفاصيل الكافية، إن لم يبادر إلى توظيف النعت والحال والخبر.
وهكذا، نرى أنه لا بدَّ من التمسّك بالأصالة اللغوية، والحرص على ريادة لغتنا العربية في النقد، والولوج إلى أعماق النصوص، واستكناه جمالاتها. ولا بدَّ أن نقف بالمرصاد في وجه من يحاول كسر شوكـة البحث اللغوي، أو تنحيته، أو تهميشه.
ولا ننسى أنَّ قرآننا العظيم كان مفتاح الإيمان به فكرة الإعجاز، وهل الإعجاز في جوهره إلا لغوي السمت؟
المصدر : د. أيمن أحمد رؤوف القادري - دكتور وأستاذ جامعي
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"



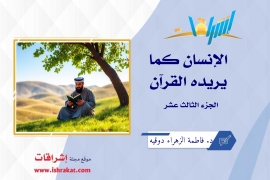


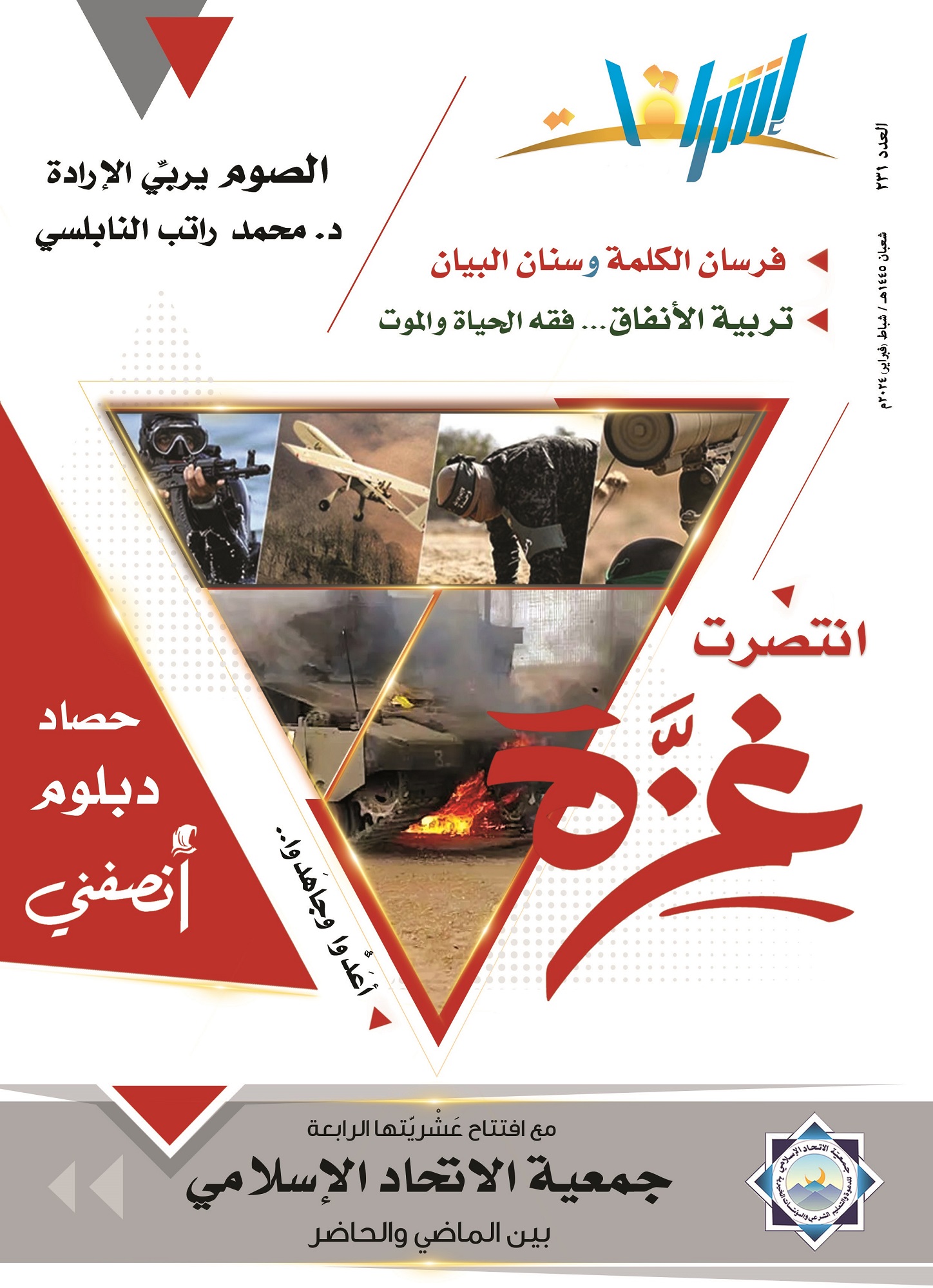


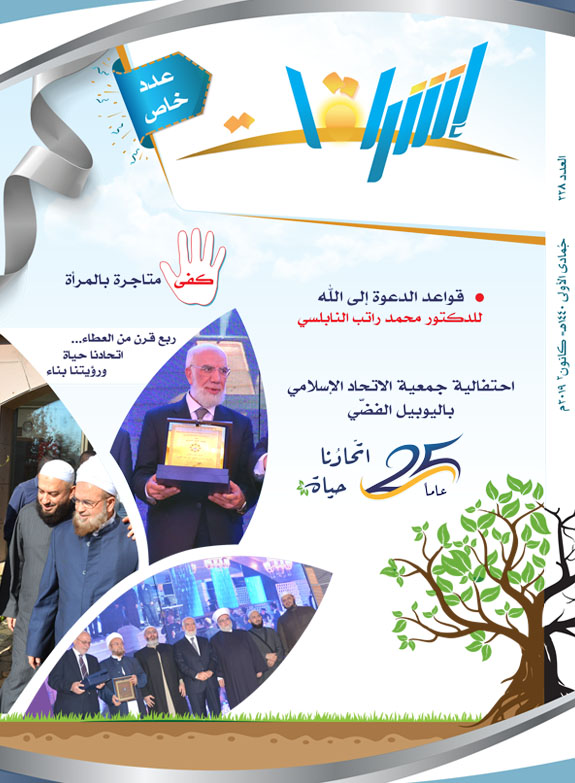










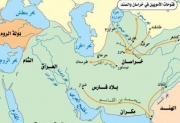
دروس إيمانية من شهر رمضان المبارك
الإنسان كما يريده القرآن - الجزء الثالث عشر
من مزايا الصيام.. أضواء وبيان
فضائح إبستين في ضوء الشريعة الإسلامية – قراءة أخلاقية وقِيَمِيَّة
أهمية الوعي حول تأثيرات الأفلام الكرتونية