ما تطمئنّ إليه النّفس أنَّ اللّغة العربيّة كانت هي لغة العرب العاربة، ومنهم العرب البائدة (قوم عاد وثمود..)، والعرب الباقية (قوم جُرْهُمَ وقَحْطَانَ وحِمْيَرٍ..)، حتّى ظهر إِسْمَاعِيلُ عليه السّلام، فصارت نقلة عظيمة في عالـم اللّغة العربيّة، ومعه نشأت العرب المستعرِبة.
فقد طلبت جُرْهُم الاستقاء من بئر زمزم عند السّيّدة "هـاجر" بمكـة، إذ لم يكن لهم في الـماء شيء إلّا ما يشربون منه، وينتفعون به، فاستأنست "هاجر" بهم، ثمّ لـمّا ترعرع الغلام، وشبّ، تزوج من جُرْهُمَ.
جاءَ في الحديثِ الصّحيحِ الّذي رواه البخاريّ (265هـ) عن ابن عبّاس (رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا) أنّه لـمّا ضرب جِبْرِيلُ عليه السّلام الأرضَ، نبعَ ماءُ زمزم، وجاءتْ قبيلة جُرْهُم، ونزلوا عند أُمِّ إِسْمَاعِيلَ. قَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّـم: "فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْماعِيلَ، وَهِيَ تُحِبُّ الْإِنْسَ، فَنَزَلُوا وَأَرْسَلُوا إِلى أَهْلِيهِمْ، فَنَزَلُوا مَعَهُمْ، حَتَّى إِذا كانَ بِها أَهْلُ أَبْياتٍ مِنْهُمْ، وَشَبَّ الْغُلامُ، وَتَعَلَّـم العربيّة مِنْهُمْ وَأَنْفَسَهُمْ، وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ، فَلـمّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ".
وعلَّق اَلْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ (852 هـ)، رَحِمَهُ الله تَعَالى، على العبارة (وَتَعَلَّـم العربيّة مِنْهُمْ)، قائلًا: "فِيهِ إِشْعار بِأَنَّ لِسَان أُمّه وَأَبِيهِ لـم يَكُنْ عَرَبِيًّا، وَفِيهِ تَضْعِيف لِقَوْلِ مَنْ رَوَى أَنَّهُ أَوَّل مَنْ تَكَلـم بِالعربيّة".
ثمَّ نقل أيـــــــضًا حَدِيث عَلِيّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ: "أَوَّل مَنْ فَتَقَ اللهُ لِسَانه بِالعربيّة الـمبِينَة إِسْمَاعِيل".
وخرج بالنّتيجة التّالية: "بِهَذَا الْقَيْد يُجْمَع بَيْن الْخَبَرَيْنِ فَتَكُون أَوَّلِيَّته فِي ذَلِكَ بِحَسَبِ الزِّيَادَة فِي الْبَيَان لا الْأَوَّلِيَّة الـمطْلَقَة، فَيَكُون بَعْد تَعَلّـمه أَصْل العربيّة مِنْ قبيلة جُرْهُم، أَلْهَمَهُ الله العربيّة الْفَصِيحَة الـمبِينَة فَنَطَقَ بِهَا".
إذًا تَعَّلـم إِسْمَاعِيلُ عليه السّلام أصل اللّغة من قبيلة جُرْهُم، ثُمَّ ألهمه الله النّطق بالعربيّة الفصحى. وهكذا كانت النّبوّة منعطفًا حسّاسًا في بلورة اللّغة العربيّة. ومن نسل إسماعيل، عليه السّلام، كانت قريش.
وقبيل مبعث النبي محمد، عليه الصّلاة والسّلام، بدأ المنعطف الحسّاس الآخر.
قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: "إنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنانَةَ مِن ولَدِ إسْماعِيلَ، واصْطَفَى قُرَيْشًا مِن كِنانَةَ، واصْطَفَى مِن قُرَيْشٍ بَنِي هاشِمٍ، واصْطَفانِي مِن بَنِي هاشِمٍ" رواه مسلم (261هـ).
ويدخل ضمن هذا الاصطفاء قوله تعالى: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} [الأنعام، 6/124]، و"حيث" هنا أساسًا دالّة على المكان، وقد رأى مفسِّرون أنّها مجازيّة، إذ خرجت عن الدّلالة على المحلّ، لتعبّر عن الحالّ فيه، وهو النّبيّ محمّد، عليه الصّلاة والسّلام. ولكنّ ظاهرها يوحي بأنّ اختياره للنّبوّة اقترن باختيار المكان، قال البيضاويّ (685هـ) في تفسيره: "وهو أعلم بالمكان الّذي يضعها فيه". وهذا المكان هو مكّة، الّتي تربّعت على عرش زعامتها "قريش"، فبسطت بذلك نفوذها الدّينيّ على باقي القبائل. وهذا النّفوذ يرجع إلى بناء إبراهيم وإسماعيل، عليهما السّلام، الكعبة في مكّة.
وهنا يأتي التّساؤل: ألم يكن علماء اللّغة يرجعون إلى قبائل "نجد" لضبط معايير الفصاحة؟ فلماذا الحديث عن زعامة قريش اللّغويّة؟
نحن إزاء مصطلح الفصاحة في كتب الأقدمين أمام مفهومين: الفصاحة اللّغويّة والفصاحة البلاغيّة.
فالفصاحة الّتي يتحدّث عنها اللّغويّون تعني الدّقّة المـعجميّة، وصحّة السّبْك، وهذه استندوا فيها إلى قبائل "نجد" الرّاسخة في صون اللّسان، وهي أسَد وتَميم وقَيْس وطَيِّئ، وهُذَيل، كما ذكر أبو نصر الفارابيّ (339هـ) في "كتاب الحروف"، وعلّل استثناء الآخرين بأنّهم كانوا "مخالطين لغيرهم من الأمم، مطبوعين على سرعة انقياد ألسنتهم لألفاظ سائر الأمم المطبقة بهم، من الحبشة والهند والفرس والسّريانيّين وأهل الشّام وأهل مصر."
أمّا الفصاحة الّتي يتحدّث عنها علماء النّقد والبلاغة، فتعني انتقاء الأجمل بين اللّهجات الصّحيحة، وهذا ما أتقنته قريش، الّتي هضمت لهجات نجد، عبْر استضافتها السّنويّة لقبائلها، وقبائل سائر العرب، وإقامة الأسواق الأدبيّة الجامعة لكلّ القبائل، ومن أشهرها سوق "عُكاظ".
وفي ذلك قال أحمد بن فارس (395هـ) في "الصّاحبيّ": "وَكَانَتْ قريش، مع فصاحتها وحُسن لغاتها ورِقَّة ألسنتها، إِذَا أتتهُم الوُفود من العرب تخيّروا من كلامهم وأشعارهم أحسنَ لغاتهم وأصفى كلامهم. فاجتمع مَا تخيّروا من تِلْكَ اللّغات إِلَى نَحائرهم وسَلائقهم الَّتِي طُبعوا عَلَيْهَا. فصاروا بذلك أفصح العرب".
ولا بدّ من إيضاح أنّ أشهر القبائل الّتي تُروى لها لهجات خاصة تختلف عن اللّغة الأدبيّة المثاليّة، كان لها شعراء كثر، لكنّهم مقلّون، وليسوا من الطّبقة الأولى، والشّاعر من غير قريش صار يتحاشى خصائص لهجته، ويتبنّى خصائص لهجة قريش، بـما اصطفت من كلام القبائل.
وقد نظر الكاتب العراقيّ مهديّ المخزوميّ (1993م) في كتابه "مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللّغة والنّحو" إلى الفصاحة بمفومها الثّاني، حين قال: "لو كان مقياس الفصاحة هو الانعزال في كبد الصحراء، من دون الاتِّصال بالأجانب، لكانت قريش أبعد اللّغات عن الفصاحة. ولا قائِلَ بهذا".
وقال قريبًا من ذلك أحمد مختار عمر (2003م) في "البحث اللّغويّ عند العرب": "إنّهم لـم يكونوا على حقّ في ربطهم الفصاحة بالبداوة... وليس من الحقّ أن نعدّ لغة البدويّ أرقى من لغة الحضريّ..".
وأكملت قريش مشروعها في إرساء الفصاحة البلاغيّة عبرَ قناة أخرى، وهي إرسال الأطفال رُضَّعًا إلى بادية نجد، كي يستقيم لسانهم.
ولهذا نقلوا حديثًا صحيح المعنى، غير صحيح السَّند، يَنْسُبُ إلى النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، تعليلَ ارتقائه في الفصاحة بأمرين: أنّه من قريش، وأنّه نشأ في بني سعد، وهم مِن نجد.
والحديث هــــــو: "أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِب، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَا أَعْرَبُ الْعَرَبِ، وَلَدَتْنِي قُرَيْشٌ، ونَشَأْتُ فِي بَـــنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، فَأَنَّى يَأْتِينِي اللَّحْنُ؟". رواه بهذا اللّفظ أبو القاسم الطّبرانيّ، في "الـمعجم الكبير".
وهذا الحديث ورد بألفاظ متباينة، لم يصحّ منها شيء، وقد ذكر ذلك أبو الفداء الـعجلونيّ (1162هـ) في "كشف الخفاء ومزيل الإلباس عـمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس".
وبعد أن احتوت قريشٌ هذا المزيج، عملت على الانتخاب الذّوقيّ، والغربلة الفنّيّة، وصارت بإجماع العلماء رائدة الفصاحة بمعناها الفـنّيّ، الّذي ابتُنِيَ على المعنى اللّغويّ. نقل أحمد بن فارس في "الصّاحبيّ" عن بعض أهل العلم: "أجمَعَ علماؤنا بكلام العرب، والرُّواةُ لأشعارهم، والعلماءُ بلُغاتهم وأيامهم ومَحالّهم أنّ قُرَيشًا أفصحُ العرب ألْسنةً وأصْفاهم لغةً".
ومفهوم هذه الفصاحة الّتي احتضنتها قريش، ونزل بها القرآن: خلوص الكلام من ضعف التّأليف وتنافر الكلمات والتّعقيد، مع فصاحة الكلمات الـمفردة، كما يقول الخطيب القزوينيّ (739هـ) في "الإيضاح في علوم البلاغة".
والقرآن الكريم حافظت تراكيبه على سلاسة التّراكيب، وانفرد بتراكيب جديدة الـنّمط، وتخلّى عن كثير من الألفاظ الصّعبة الّتي حفل بها الشّعر الجاهليّ. قال أبو بكر الباقلانيّ في "إعجاز القرآن": "سهل سبيلُه، فـهو خارجٌ عن الوحشي والمستكرَه، والغريب المستنكر". وقال عبد القاهر الجرجاني (471هـ) في "دلائل الإعجاز": "وأنت تقرأ السّورة من السُّوَرِ الطِّوال، فلا تجِد فيها من الغريبِ شيئًا".
وإنّ لـهجات القبائل الغريبة والضّعيفة والمتدنّية في رتبة الفصاحة، عزف عنها النّصّ القرآنيّ، وسلك مسلكًا محمودًا في البلاغة، وهـو غربلة هذه اللّهجات، فقد أدرج منها في آيِهِ ما استقامت قوّته اللّغويّة، واستساغه الذّوق العربيّ.
وهكذا، هيّأ الله لهذا القرآن المعجز وعاء ثمينًا يجدر أن يحتضن أرقى كلام، فكانت اللّغة العربيّة الّتي هذّبها الإلهام إلى إسماعيل، عليه السّلام، ثمّ كانت الأسباب الّتي جعلت قريشًا تؤول إليها الزّعامة اللّغويّة، لأنّ حامل نور القرآن الكريم سيكون خير فتيانها.
يبقى السّؤال: إذا كان تبلور اللّغة العربيّة قد مرّ بمحطتين مفصليّتين ارتكزتا على النّبوّة ومكّة، فما الّذي يمنع أن تكون المحطّة الأولى مع النّبيّ آدم، عليه السّلام، وهو الّذي اقترن اسمه أيضًا ببناء الكعبة؟ ألا يفيدنا ذلك في تبنّي أنّ لغته كانت العربيّة؟
الجواب أنّ بناء آدم عليه السّلام للكعبة لا يثبت. لقد روى الأزرقيّ (250هـ) في "أخبار مكّة" والبيهقيُّ (458هـ) في "دلائل النّبوّة"، وغيرهما، أخبارًا كثيرة في هذا الشّأن، لكنّها لا ترقى إلى الصّحّة أو ما يدانيها.
وهكذا نؤكّد أنّ الجدل بشأن آدم عليه السّلام، واللّغة العربيّة، ليس لدينا فيه ما يسعف للمضيّ قُدُمًا بقوّة.
إنّها لغتنا العظيمة، يجدر بنا أن نتقصّى كلّ تفاصيل نشأتها، ونستجلي ماضيها، على أن لا نبقى أسرى ذلك الماضي. لا بدّ من قفزات نوعيّة تستشرف الغد الباسم لهذه اللّغة، وتتوثّب لزعامـة جديدة، قد تكون مقدّمة لزعامة أوسع من نطاقِ اللّسان.




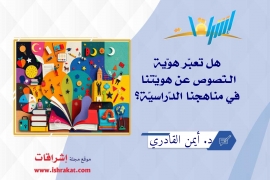


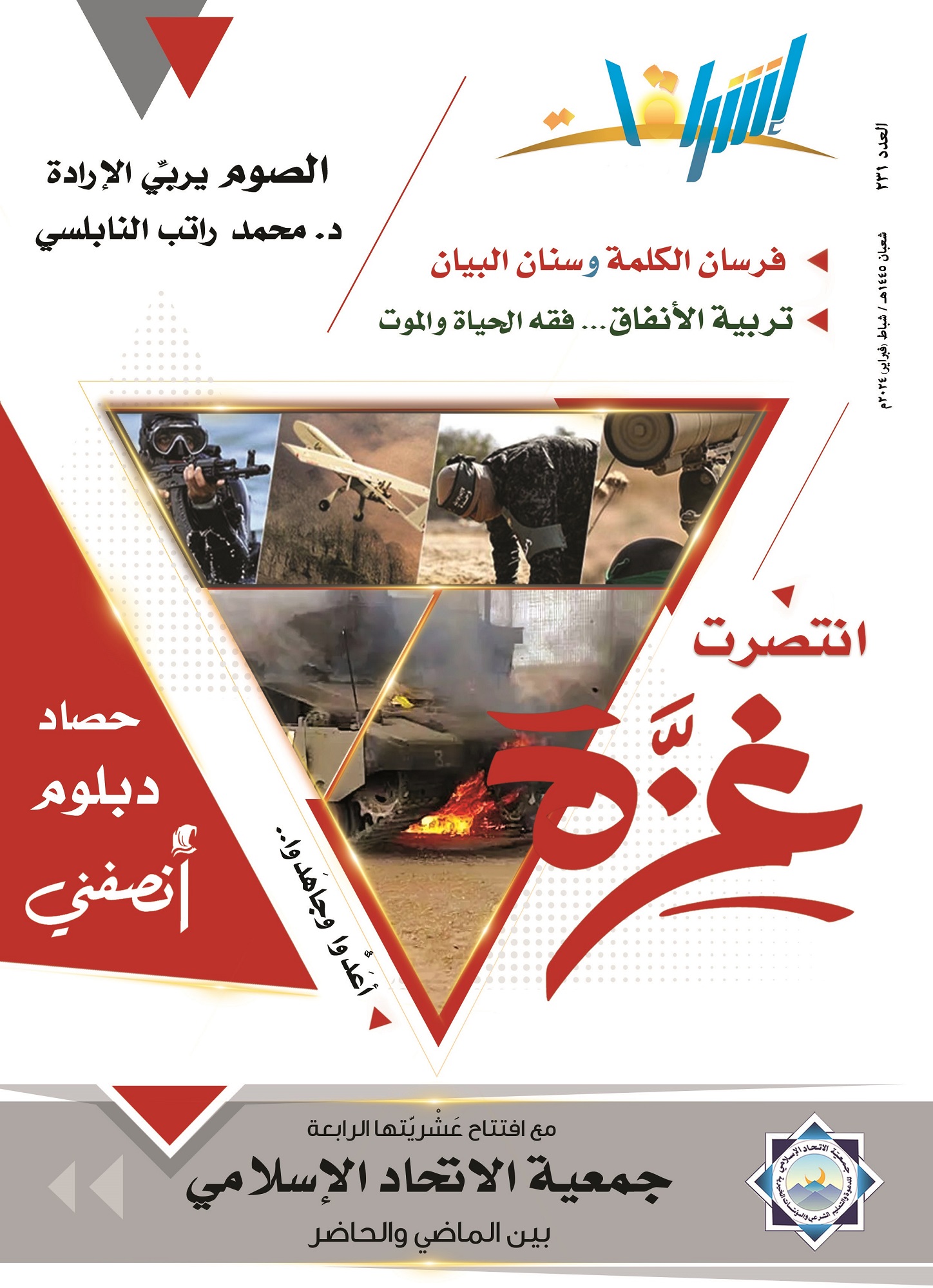


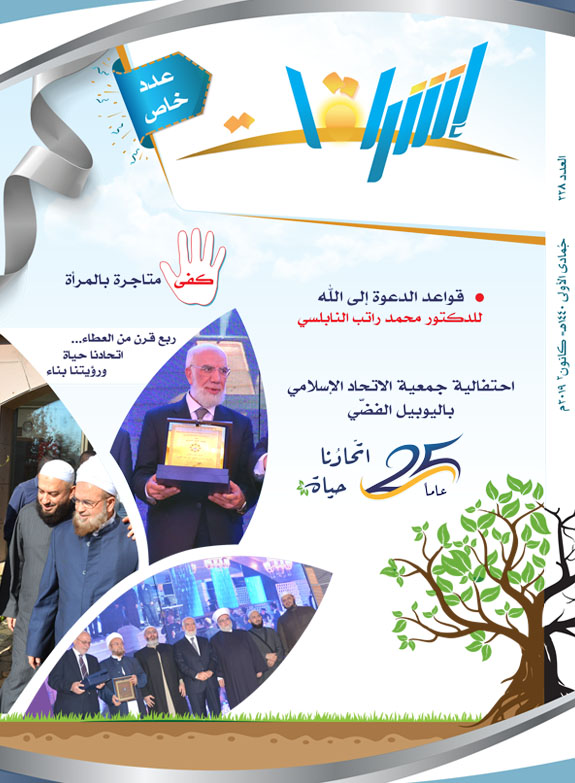










أهمية الوعي حول تأثيرات الأفلام الكرتونية
كتاب 'صراع الدول الأوروبية على فلسطين في القرن التاسع عشر'
لماذا أتحجَّب؟
هل تفاجأتم بفضائح إبستين؟
عَظٌمتْ آثارُهم على الرغم من قِصَر أعمارهم