تقف اللّغة العربيّة في مهبّ الأعاصير، منذ قرون، تـثبت جدارتها، عنيدةً لا ترضخ لقرارات الإقصاء، ولا تلفظ عبارات الاستسلام، على الرّغم من تلاحُقِ المؤامرات، وقِلَّـة الجهود الّتي تبذلها الجهات الفاعلة في هذا الإطار، ولا أعني المجامع اللّغويّة، فهي لا تملك الصّلاحيّات التّنفيذيّة، وتبقى جهودها المباركة وتوصياتُها، بانتظار أن يُفرَجَ عن القرار السّياسيّ لتبنِّــيها.
وإنّ الدّخول إلى القضايا الّتي تشغل المعنيِّـين باللّغة العربيّة، كالدّخول إلى أهرام مصر، وإنّي، وإنْ كنت لا أخشى أن تصيبنا لعنة الفراعنة، أخشى أن نضيع في زحمة هذه القضايا، لتعدّد الأنفاق، وتشعّب السّراديب. ولن أَمدَّ أحدًا السّاعةَ بخريطةٍ لنمضي قُدُمًا في هذه الأنفاق، بل سأكتفي بجبهة واحدة من الجبهات الملتهبة الّتي تحارب فيها هذه اللّغة أعتى خصومها.
وهذه الجبهة هي الّتي تُقلِق كلَّ مدرِّس لـلُّغة العربيّة، إذ يرى اللّغة الأجنبيّة، أيًّا كانت، تختلس من نصيـبها، على مرأى ومسمع من إدارات المؤسّسات التّربويّة. نعم!! غُزِيتِ اللّغة العربـيّة في عقْر دارِها، واستُـبيحَتْ حرُماتُها، وصارتْ ضيفةً غليظةَ المنطق، ثقيلة الظّلِّ، يتفادى الطّلبة الاحتِكاك بها، وكأنّها مَن وصفه النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، بقوله: "إنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَومَ القِيَامَةِ مَن تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ" [رواه البخاريّ]! ولولا الطّاقة المكنونة الّتي أودعها الله هذه اللّغة، ولولا بأس الصّناديد من أهل هذه اللّغة، لما قرأتُم ما تَرَونَه اليومَ من أسطري، إلَّا وبين أياديكم ما يُحيلُكم إلى مترجم فوريٍّ!
والأمر يـبلغ ذروة ضرره حين تُدرَّس العلومُ الحديثة بلغة غير اللّغة الأمّ، العربيّة، تحت ذريعةِ أنَّها لا تستوعب تلك العلوم الحديثة! ولن أطيل في هذه المسألة، بل أكتفي بالإشارة إلى أنّ الكلّيّة الإنجيليّة السّوريّة في بيروت، وهي الّتي تعرف اليوم باسم الجامعة الأمريكيّة، تأسّست عام 1866م، واعتُمدت العربيّة لغة التّدريس في كلّيّتي الطّبّ والصّيدلة فيها، ولكنها أُقصيت عنهما سنة 1884م، وحلَّت الإنجليزيّة محلَّها لأسباب نحن في غنى عن شرحها الآن، لكنَّ العربيّة منها براء.
كلامي اليومَ سيركّز على أصل هذه العلّة، حين سمحنا للدّبّ أن يدخل إلى كرمنا.
إذًا، سنـتحدّث عن مبدأ تدريس اللّغة الأجنبيّة في مدارسنا، ذلك التّدريس الّذي يصعق الطالبَ منذ نعومة أظفاره، ويسلخه عن هويّته بالقدر الّذي يسمح به غضُّ الأهلِ الطَّرْفَ، وقصورُ مدرِّسِ اللّغة العربيّة، ورداءةُ الكتب الّتي تقدِّم مادّتها.
لسنا في صدد إنكار ضرورة تعلّم اللّغات الأجنبيّة، فمن تعلّم لغة قومٍ أمن مكرهم، قال الصّحابيّ الجليل زيد بن ثابت (45ه)، رضي الله عنه: "أمرَني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن أتعلَّمَ لَهُ كتابَ يَهودَ، قالَ: إنِّي واللَّهِ ما آمَنُ يَهودَ علَى كتابي، قالَ: فما مرَّ بي نِصفُ شَهْرٍ حتَّى تعلَّمتُهُ لَهُ، قالَ: فلمَّا تَعلَّمتُهُ كانَ إذا كتبَ إلى يَهودَ كتبتُ إليهِم، وإذا كتَبوا إليهِ قرأتُ لَهُ كتابَهُم". [رواه الـتّرمذيّ]، والـمراد بـــ"الكتاب" هنا "الكتابة".
ولسنا نحذِّر من التّكلّم باللّغات الأجنبيّة، كما فعل مَن تعلّقوا بحديثٍ واهي الإسناد: "من يُحسِن أن يتكلَّم العربيّة، فلا يتكلّم بالعجمة، فإنّها تَرِثُ النِّفاقَ" [رواه الحاكم وسكت عليه وردّه الذّهبيّ]. لكنّ الأمر الّذي نحذِّر منه هو أن تستبدّ اللّغة الأجنبيّة، وتصبح مقصودة لذاتها، ويغدو إتقانها عنوانَ الرّفعة بين الأمم. ربَّـما لذلك قال عمر بن الخـطّاب (23ه)، رضي الله عنه: "لا تَعَلَّمُوا رَطَانة الأعاجم..." [رواه عبد الرّزّاق والبيهقيّ وابنُ أبي شَيبة بإسناد صحيح].
***
وإليكم قائمة بأبرز الأخطار:
تحمل دراسة أيّ لغة في ثناياها تفاصيلَ الحضارة الّتي سطّرت معالمها بها، وعناوين الثّقافة الّتي عبّرَتْ عنها أدبيّاتُها. ولذلك لا يمكن الفصْل بين اللّغة وحضارتها، كما لا يمكن الفصل بين الجسد والروح، إلَّا بالموت.
وإنّ من ينشأ على قراءة نصوص أنتجها أدباء غربيّون، لا بدّ أن تـتسرّب إلى وجدانه، وتفيض كلامًا على لسانه، وتُترجَم سلوكًا في حركاته وسكناته.
وثـمّة علاقة بين تعلّم اللّغة الأحنبيّة والهجرة، هجرة الأدمغة على وجه التّحديد، فالطّفل العربيّ الّذي لا يتحدّث العربيّة يفقد هويّته وأصوله وجذوره، ويتعسَّر عليه التّكيّف الاجتماعيّ. وعندما يكبر، يفكّر أكثر من أقرانِه في الهجرة، فاللّغة، وإن كانت وسيلة اتّصال بين الأفراد، إلّا أنّها أيضًا سلوك عقليّ وحركيّ واجتماعيّ وانفعاليّ.
ويصعب على الطّالب الطّفل أنْ يجمع بين أسس لغتين يتلقّاهما معًا، وفي كلّ منهما حروف متباينة، رسمًا، ولفظًا، واتجاهَ كتابة، وفي كلّ منهما أصول مختلفة في تركيب الجملة. قال الله تعالى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ}، وقال الجاحظ (255ه) في "البيان والتّبيين": "واللُّغتانِ إذا التَقتَا في اللَّسان الواحد أدخلت كلُّ واحدةٍ منهما الضّيمَ على صاحبتها".
***
ولقد اختلف أهل الـتّربية في التّعلّم المبكر للّغة الأجنبيّة، فمنهم من يرى أنّ أحسن سنّ للبدء في تعلّم لغة أجنبيّة هي بين العاشرة والثّانية عشرة؛ بعد أن يتلقّى الطّالب مهارات لغته بنجاح، وقبل ذلك يكون التّعلّم اللّغويّ غالبًا بطيئًا في اللّغتين وغير مجدٍ. وتُظهر قاعدة بيانات "اليونسكو" العالـميّة بشأن التّفاوت في مجال التّعليم أنّ الأطفال الّذين يتلقّون التّعليم باللّغة الّتي يتكلّمون بها في المنزل، يزيد احتمال إتقانهم لمهارة فهم النّصوص المقروءة في نهاية المرحلة الابتدائيّة بمقدار 30٪ عن الأطفال غير النّاطقين بلغة التّدريس على مستوى العالم. وتُبيّن الأدلّة أيضًا أنّ التّعلُّم باللُّغة الأولى أو باللّغة الأمّ يحسّن مهارات الأطفال الاجتماعيّة. وذلك الأمر مذكور في منصّة "اليونيسكو" الرّســميّة بتاريخ 16 من شباط، عام 2003م.
ويرى آخرون أنّ السّنوات الثّلاث الأولى من عمر الطفل، وهي المرحلة الّتي تُسمّى بـ"الفترة الحرجة" من عمر الإنسان، يكون فيها اكتساب اللّغة سهلًا، لأنّ مرونة المخّ قبل فترة البلوغ تمكّن الطّفل من المحاكاة اللّغويّة، ويصعب الأمر بعدها.
ويقف الطّرف الثّالث حائرًا بين الطّرفين المذكورين، أو آخِذًا في الحسبان ظروفَ كلّ لغة، وظروف كلّ منهج تعليميّ.
***
ولسنا هنا في وارِد حسْم خلاف يمتدّ إلى عقود خالية. إلّا أنّ من شأن هذه الأسطر أن تبعثَ الحماسة للخروج من عنق الزّجاجة، حيث يضعنا الكثيرون، إذ يصرّون علينا أن نسجد أمام صنم اللّغة الأجنبيّة، مسبِّحين، جاعلين لها الأولويّة في الاهتمام، مبالغين في العناية بها، عبر مضاعفة عدد الحصص الممنوحة لها، وتسليط أنواع العقوبة على من لا يتكلّم بها في الملعب، واستخدامها لتعليم كلّ مجالات الثّقافة العامّة، والموادّ العِلميّة.
ولَعَمْري، إنّ هؤلاء يجدون الانطلاق في مضمار العلم والتّطوّر مقصورًا على باب واحد، يمنعون غيره، حتّى يصِحّ أن نردّد على مسامِعِهم ما قاله النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، للأعرابيّ: "لقد حجّرْت واسِعًا" [رواه البخاريّ]! إنّ اكتساب الثّقافة أعظم شأنًا من أن يُحشَر في مناهجَ جامدة، انتُقِيَت من دون نظرائِها، لا لشيء إلَّا أنّها تحقِّق الغلبة للُّـغات الأجنبيّة!
وهنا أقول: هذا الأمر يصدق على اللّغة الأمّ عامّة، فكيف إذا كانت هذه اللّغة هي اللّغة العربيّة؟ آنذاك لا بدّ أن نردّد أبيات الشّاعر حليم دَمُّوس (1377ه=1957م):
|
لو لم تكُنْ أمُّ اللّغـاتِ هيَ الـمُنى
لغـةٌ إذا وقعـتْ عـلى أسماعِنا
سـتظلُّ رابطـةً تُؤلِّـفُ بيننا
وتقارُبُ الأرواحِ ليـسَ يَضـيرهُ
أفما رأيـتَ الشَّمسَ وهْيَ بعيدةٌ
أنا كيفَ سِرتُ أرى الأنامَ أحبتي
|
|
لكسرْتُ أقلامي وعِفتُ مِدادي
كانتْ لنا بَرْدًا على الأكبادِ
فهيَ الرَّجـاءُ لناطـقٍ بالضّادِ
بينَ الدِّيارِ تباعُـدُ الأجسـادِ
تُهـدي الشُّعاعَ لأَنْـجُدٍ ووِهادِ؟
والقـومَ قومي، والبلادَ بلادي
|




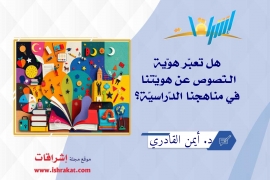
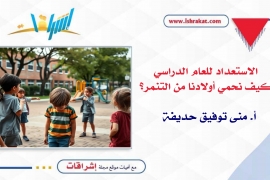
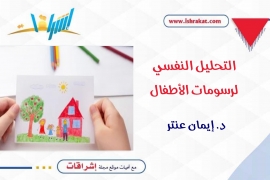

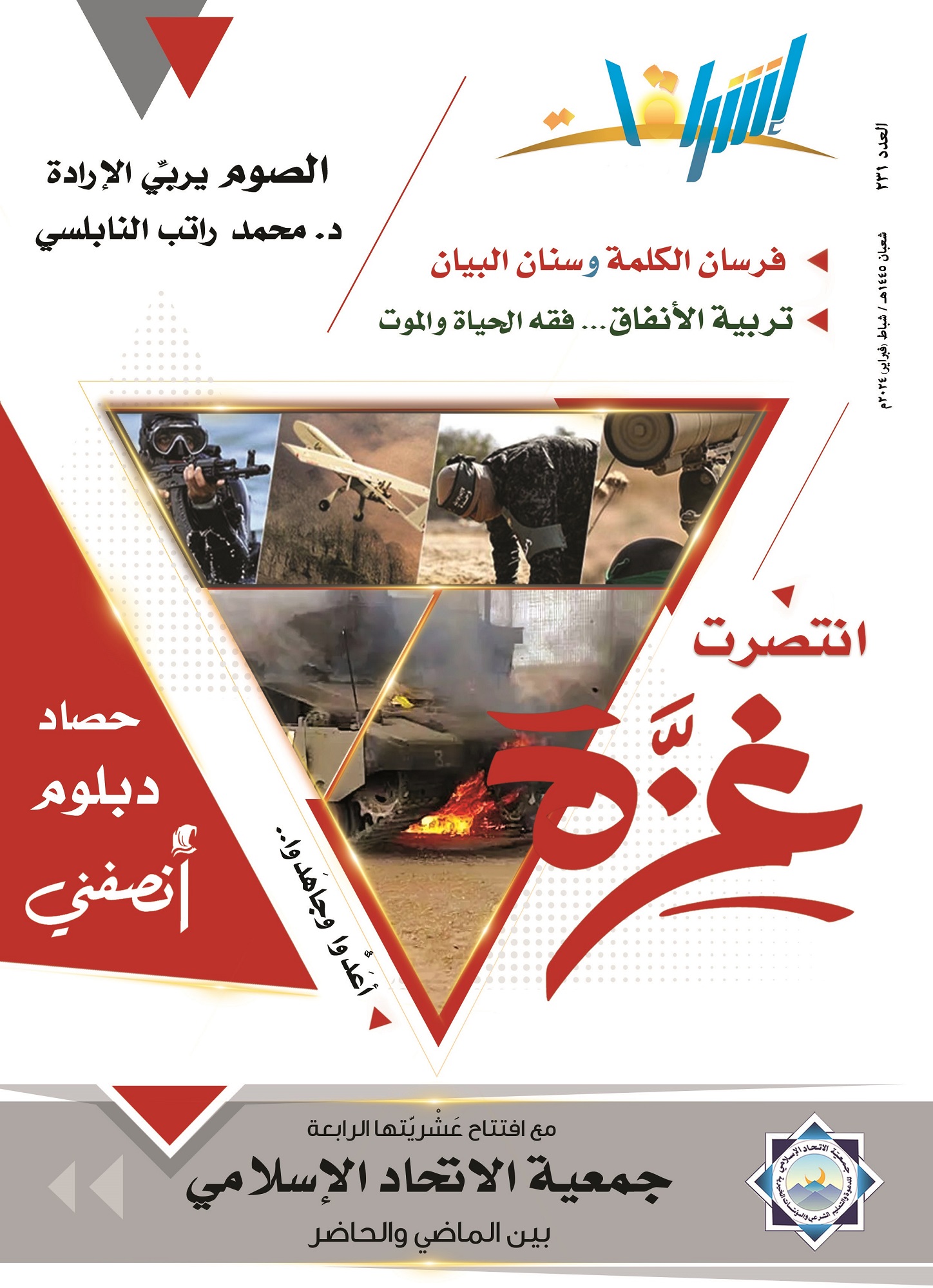


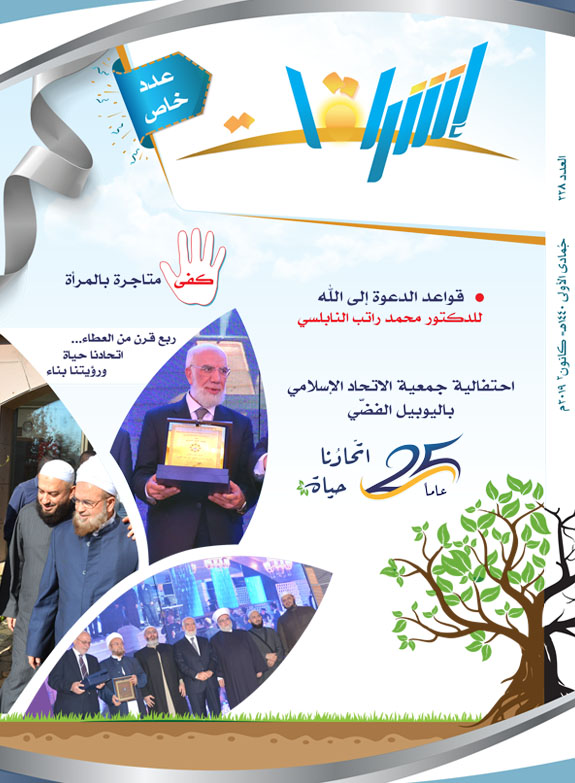










فضائح إبستين في ضوء الشريعة الإسلامية – قراءة أخلاقية وقِيَمِيَّة
أهمية الوعي حول تأثيرات الأفلام الكرتونية
كتاب 'صراع الدول الأوروبية على فلسطين في القرن التاسع عشر'
لماذا أتحجَّب؟
هل تفاجأتم بفضائح إبستين؟